“الطيب الصديقي”.. ألف حكاية لرجل المسرح في المغرب
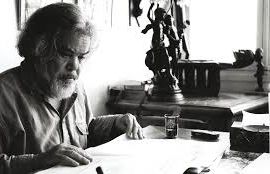
عندما تجد نفسك في إحدى الساحات العامة المغربية، تكون في اللحظة نفسها في متحف وفي مهرجان لعروض الفرجة والاحتفال، فالأبنية من حولك تؤلّف بسلاسة بين الطراز العربي الأندلسي والهندسة الغربية الحديثة، وما يعترضك من حلقات للقص الشعبي أو عروض الرقص أو العاب سحرية، أو ترويض للأفاعي على أنغام الناي يثير دهشتك.
ومن البديهي أن تأتلف هذه المفردات في المنجز الثقافي، ويرتقي إلى مصاف الإبداع، فكان مسرح الحلقة الذي شكّل عصب الأساس في سيرة المبدع المسرحي الطيب الصديقي، لكن ليس الرجل مجرّد انعكاس لسياق ثقافي فحسب، فائتلاف هذه اللبنات يحتاج موهبة فطرية وقدرة فذّة، تلك هي الرسالة التي عمل على إبرازها الفيلم الوثائقي “الطيب الصديقي.. 1000 حكاية” الذي أنتجته الجزيرة الوثائقية (2021)، وأخرجه رشيد حمّان.
جريدة مجانية لمن ينصت للأداء.. نشأة مسرحية
يبدأ الفيلم بتعريفنا بنشأة المسرحي الطيب الصديقي، بداية من ولادته عام 1937 في بيت علم بمدينة الصويرة ذات التاريخ المتشعب، وتلقي تعليمه الابتدائي بها، إلى غلبة حبّ التمسرح وعرض الذات أمام الجمهور عليه، لذلك كان يسلّم الجريدة مجانا لمن يستمع إليه وهو يقرأ بعضا منها على طريقته، حين كان طفلا يبيع الجرائد.
وبعد انتقال عائلته إلى مدينة الدار البيضاء، ونيله شهادة الثانوية العامة (البكالوريا)، حصل على منحة للتكوين المسرحي في فرنسا، وسافر إليها وهو ابن 16 عاما، بعد معاندة وإصرار إثر رفض جدّه المحافظ لرحلته.
هناك اختار أن يعيش المسرح تطبيقا وممارسة أكثر من الدراسة النظرية والأكاديمية، وأدى أصعب الأدوار على مسارح باريس، لكن عزمه على النهوض بالمشهد المسرحي في المغرب دفعه للعودة إلى الديار، فقد كان لديه شعور أن المغرب يحتاجه أكثر من فرنسا، كما يذكر الصديقي الشاب المفعم بالحماسة لإحدى نشرات الأخبار الفرنسية.
ثروة التراث.. مخزون فرجوي يكسر الجدار الرابع
عند عودته إلى المغرب أظهر الطيب الصديقي انتباها شديدا للمخزون الهائل من فنون الفرجة في فضائه الثقافي، وعمل على استلهامه من الناحية السينوغرافية (تأثيث المسرح)، فتحوّل الركح الثلاثي الجدران في العلبة الإيطالية الكلاسيكية إلى بساط ورياض وحلقة، وكسر جدار الرابع الوهمي، مستندا إلى خلفياته البريشتية (نسبة إلى المسرحي الألماني برتولت بريشت).
والبساط في الأصل هو فناء المنزل التقليدي الذي تنفتح فيه مختلف الغرف، والرياض هي الشرفة الأولى التي تطل على البساط، حيث القوس والبيت المفتوح، فيصبح لفضاءِ العرض امتداد عمودي يجمع بين الطابق الأرضي والطابق العلوي، كثيرا ما كان يوظّف للإيحاء بدلالات تستمدّ من جوهر بنائه الهندسي.
والحلقة هي تجمع الحشود حول صانع الفرجة في الساحات العامة. وأصلها حرية المتفرّجين، عند متابعة العروض في الشوارع، والتساوي بينهم. فالجميع يتحلّق حول العارض متى أراد. وله أن يجلس إن شاء أو أن يتابع العرض واقفا، وله أن يغادر متى شاء.
حفظ الذاكرة.. تراث من عمق الثقافة الشعبية
كانت للتحولات العميقة التي أدخلها الطيب الصديقي على الفضاء المسرحي تبعات على تصوّر الممارسة المسرحية عامة. فكان يعيد الاشتغال على محكيات مغرب الستينيات وتراثه الشفوي والفرجوي عامّة. فيرسّخ ما كان يسير منه نحو التلاشي من الذّاكرة، ونحو الانقراض من الممارسة، بسبب الحماسة المفرطة لكل ما يتعلّق بالمعاصرة.

وكان يبحث عن المحلّي الخاصّ، فيجعله منطلقا للبحث عن المشترك الإنساني الكوني، وفتَح العرض على المخزون الموسيقي، وجعل مسرحية “المجدوب” مثلا تنفتح بغناء لفرقة ناس الغيوان، فتردد الأشعار التي يسهل انتزاعها من سياقها وإسقاطها على الواقع. فكان مما أنشدوا:
يا ويل من طاح في بير
وصعب عنو طلوعو
فرفر ما صاب جنجين
بكى ما نشوفو دموعو
فجعل من المغنّى ممثلا يسقط خطابه على معاناة المناضلين في “سنوات الرصاص”، أي سنوات القمع الأمني الشديد في المغرب، إثر محاولة اغتيال الملك الحسن الثاني والاستيلاء على مؤسسة الحكم في سبعينيات القرن الماضي.
وعلى العموم مثّلت تجربة الرّجل جسرا لما يصطلح عليه في الساحة النقدية المغربية بـ”المتاح الفرجوي” و”المتاح النغمي”. ولكن لم يمرّ هذا النبش في الذّاكرة ومحاولة تأصيل الخطاب الفرجوي دون عقبات سبّبها العمى الفكري الذي يتعصب إلى الحداثة وفق المنوال الغربي.
“مقامات بديع الزمان”.. اقتباسات من عمق الثقافة العربية
كان عمل الطيب الصدّيقي على مسرحة التراث مغربيا في المقام الأول، فاستلهم الحكايات الشعبية المحلية، ولكنه انفتح على التراث العربي وعلى المسرح العالمي، من خلال الاقتباسات التي قدمها على الرّكح. فقد عاد إلى التراث الأدبي والحضاري واستدعى أدب التوحيدي وأبي العلاء المعري وحكايات “ألف ليلة وليلة”، واقتبس شخصية الحلاج.
وكان يراوح في العمل نفسه بين العامية المغربية واللغة العربية الفصحى، وانخرط في “مسرح الطليعة العربي” الذي عمل على توظيف التراث ضمن أفق تقدميّ يحاول التجديد والتجريب. يشرح أحد ممثليه العرض للجمهور، في تصوّر يذكّرنا بمنجز سعد الله ونوس أو المسرح الجديد في تونس فيقول: يمكن أن يكون ساحة الحلفاويين في تونس الخضراء، ويمكن أن يكون ساحة هارون الرشيد العراقية، أو العتبة الخضراء النيلية، أو ساحة الهنود الشامية، أو ساحتنا، ساحة جامع الفنا المراكشية.
وانطلاقا من “مقامات بديع الزمان الهمذاني” على سبيل المثال، ابتكر الصديقي نصا مسرحيا جديدا سنة 1972، جمع بين بطلي المقامات بعد نحو عشرة قرون من فراقهما، فيعثر عيسى بن هشام على أبي الفتح الإسكندري صدفة وهو يراقص قردا في الساحات العامّة، ولكنّ أبا الفتح ينكر هويته أو يتنكّر لها، وهي عملية إسقاط على صورة المثقف اليوم.
وقد انفتحت تجربته أيضا على النصوص العالمية، فكان ينزّلها في سياق مغربي ضمن ما عرف عند المسرحيين العرب بمفهوم اقتباس التبيئة، أي تنزيل النص المسرحي الغربي في بيئة عربية وتحميله قضاياها، ومنه تحدّث النّقاد عن المغربة والتونسة واللبننة.

ومن أعماله الكثيرة “الوارث” (1957-1956) للمؤلف “جان فرانسوا رينيار”، وقد نقلها إلى العامية المغربية، واقتبسها رفقة أحمد الطيب العلج، ومنها كذلك “الفيلسوف”، ومسرحية “محجوبة” المقتبسة من “مدرسة الزوجات” لـ”موليير”.
قضايا العمال.. مسرح مبتكر لاستقطاب الجمهور
أسس الطيب الصدّيقي عددا من الفرق المسرحية في سياقات مختلفة منها، منها “المسرح العمالي” (1957- 1958)، وفرقة “المسرح البلدي” (1960)، وفرقة “مسرح الصديقي” (1963)، وفرقة “مسرح الناس” (1970)، وفرقة “المسرح الجوال” (1974).
ففي “مسرح العمال” الذي سانده فيه “الاتحاد المغربي للشغل” مثلا تبنى قضايا العمال، لكن دون شعارات فكرية كما يوحي الاسم، فقد كان يؤمن بأنّ المغرب في حاجة إلى نضال مسرحي وفني بعيدا عن الشعارات.
المقصود هنا هو مسرح يقدّم عروضه إلى كل المهن، وكان يستهدف قطاعات بعينها في عروض خاصّة، مما مثّل بحثا مبتكرا لاستقطاب الجمهور، وعمل على تأسيس “مسرح الناس” منطلقا من الثقافة الشعبية والفرجة، موجّها خطابه إلى كل الناس، بعيدا عن مظاهر النخبوية والتعالي.
وعامة كان الرجل يميل إلى المسرح الاحتفالي، وهو اتجاه ظهر في ستينيات القرن الماضي، ليربط بين المسرح والاحتفال والعيد، ويقدّر أننا نفهم الشعوب خلال مؤسساتها الرسمية بقدر ما نفهمها من خلال دوائر أخرى أوسع مدى، هي الثقافة غير الرسميّة والشعبية.
وكان يرى انطلاقا من مفهوم البعد الكرنفالي في منجز “ميخائيل باختين” أن الحشود تنزع إلى التمرّد على الموانع والقيود عند اجتماعها، فتحقّق شكلا من أشكال الحرية فيها. والكرنفالي في أثري باختين” أثر فرونسوا رابولاي” و”شعرية دوستوفسكي” يتجاوز الدّلالة المباشرة التي تصله بالاحتفال، ويكتسب دلالة جديدة هي خرق المحظور، والجرأة على كل ما يكرّس التّراتبيّة من مؤسسات سياسية واجتماعية، تكرّس الفوارق بين الحاكم والمحكوم والسيد والخادم، ومن قيم يفصل سلّمها بين الفظّ والمرهف أو بين الجميل والقبيح.
حافظ الأرشيف ومؤسس الحرفة.. وجه خارج المسرح
يكشف لنا الفيلم الأبعاد المختلفة للطيب الصديقي، فهو أكثر من ممثل أو مخرج مسرحي أو سينمائي، إنه المؤرخ الذي يساعد على حفظ الذاكرة الجماعية وتوثيق مختلف، حتى يمسك باللحظة ويقاوم الانمحاء والزوال، عاملا على تدارك نقيصة فن المسرح قديما، خاصة كونه ينتمي إلى الفن الزائل الذي يختفي بانتهاء العرض.

وهو الإداري الذي ينتمي إلى جيل المؤسسين الكبار الذين أسهموا في بناء مؤسسات الدولة الوطنية فيما بعد الاستقلال في كل البلدان العربية، فكان هاجسه أن يعلّم المغاربة مختلف التقنيات المسرحية، وكان يستهدف الفئات الهشة، ويقيم الورشات في الأحياء الأقل حظا.
ويذكر رفاقه مثلا أنه كان يفتح قاعة العرض أمام الطلبة للدخول مجانا حتى ينقل لهم الشغف المسرحي، ويحث المغاربة على الاحتكاك بالحرفيين العالميين في المناسبات التي تقدم فيها العروض الأجنبية، ليتعلموا منهم السينوغرافيا والإضاءة وغيرهما من المهن المسرحية، وذلك خلال تولّيه لمنصب مدير فني للمسرح الوطني الخامس بالرباط، ثم مديرا للمسرح البلدي بالدار البيضاء (1965-1977).
تنكر الساحة الفنية.. نهاية مؤلمة وصمت طويل
ظلّ الطيب الصديقي يبحث عن التحديات الجديدة التي تحفزه على الإبداع، معوّلا على ذكائه الاجتماعي وقدرته على كسب ثقة الآخرين، لكن انسحابه من المشهد الثقافي كان قاسيا، ولا يفصّل الفيلم الأسباب، لكن ابنه يذكر مثلا أنه لم يعد إلى “المسرح البلدي” منذ استقالته منه سنة 1977، إلى أن هدم سنة 1984.
فقد تركه وبه شعور بالمرارة، واعتزل المشهد الثقافي برمّته وبه شعور بالخيبة، بعد أن عاش حالما بتأسيس مسرحه الخاص الذي يفرض فيه أسلوبه، ويمارس فيه فنه بحرية، وينقل تجربته إلى الشباب من المهمشين خاصة، لكنه اصطدم بمجتمع لا يوقر المبدع.

ومن ظلال الشهادات نفهم أنه كان يؤمن بأن الحياة تمثيل، وأننا جميعا نتقمّص أدوارا فيها، ويتعيّن علينا أن نتقنها، ولإيمانه العميق هذا كان يتوخى منهج الصرامة في مهنته، لكن البعض كان يجد فيها ضربا من التسلط وعدم الصبر على الممثلين، وكان يراه سريع الغضب يعبّر عن مواقفه بأسلوب خشن أحيانا، وكأنّ المرض ورغبة البعض في جعله صفحة من الماضي يجب أن تُطوى، جعلا نهايته مؤلمة، فغدا غير قادر على الكتابة أو القراءة، وعاش الصمت، فجسّد أزمة المثقف نفسها التي اقتبسها من التوحيدي في “الإمتاع والمؤانسة”، أو ابتكرها حين جعل عيسى بن هشام صامتا ينكر هويته ويراقص القردة.
يبدو الفيلم متعاطفا مع الطيب الصديقي، فلم يكن يقدّم سيرته بقدر ما كان يجعل مادته ضربا من التأبين، فوجّه اهتمامه إلى الرجل أكثر مما عرض لنا فنه، وترك عددا من خصائص مسرحه غائمة لا تظهر بجلاء، إلا لمن كانت له دراية بمسرحه، وبالمشهد المسرحي المغربي والعربي عامة.
وقد نجد له العذر، فأغلب الشهادات صدرت عن شخصيات لصيقة بشخصه، مثل ابنه بكر الصديقي المشارك في الإعداد، والباحث عزيز المجدوب، ونور الدين بكر الممثل الذي يدين له بالكثير، كما أن للرجل مدونة مسرحية ضخمة ومسيرة متشعبة لا يستطيع فيلم مدته دون الساعة أن يحيط بها من وجوهها المختلفة.